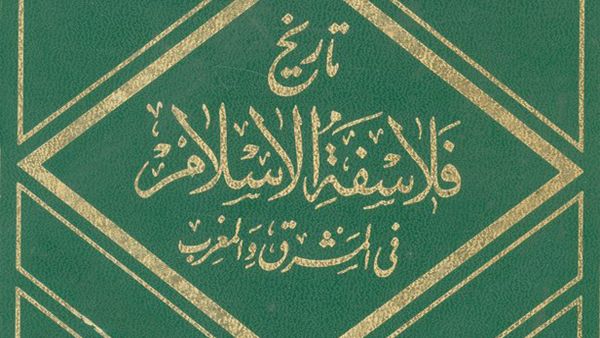تعتمد سياسة العالم اليوم على وجود فلاسفة يفكّرون ويوجدون النظريات والقوانين التي تتدخل في كل تفاصيل الحياة، ومن هنا نعلم أهمية الفلسفة ودور الفلاسفة على مدى التاريخ.
وقبل الشروع في الكلام عن فلاسفة المسلمين في التاريخ، يجدر بنا أن تعرف ماهية الفلسفة:
إنّ لفظة "الفلسفة" لا أصْلَ لها في لغة العرَب، وإنَّما هي لفظَة إغريقيَّة يونانية قديمة، ومعناها اللغوي عندهم مُترجَمٌ علىٰ أنَّها: (الحكمة) أو (حُبّ الحكمة).
ولمَّا تدَاوَلَها العربُ أصْبحَت تعني في المشهور من اصطِلاحِهم: «الأفكار الـمُستنبَطة بالعقل، وإعْمال الفِكر، حول الموجودات ومبادئها وعِلَلِها».
ويَذكُر بعض الباحثين أنَّ (الفلسفة) هي تلك اللَّفظة الإغريقية التي لا يُقابلها أيّ لفظٍ في لغة أخرىٰ، والسبب في ذلك أنها بقيت مُحافِظَة علىٰ حَرْفِيَّتِها في سائر اللغات لفظةً مُتَمَيِّزةً، وأنَّها قَد عُرِّفَت بأكثر من عشرين تعريفًا يختلف في الأسلوب واللَّفظ، وقد يتجاوز الخلاف إلىٰ أبعد من ذلك.
ولعلّ ما يهمّنا -هنا- هو ذِكر تعريفات مشاهير فلاسفة اليونان الأوائل:
فقد عرَّفها سُقراط بأنَّها «البحث العقلي عن حقائق الأشياء...».
أمَّا أفلاطون فعرّفها علىٰ أنَّها «البحث عن حقائق الموجودات».
وأمَّا أرسطو فقال: «هي العلْم العام، وفيہ تُعرَف موضوعات العلوم كلّها، فهي معرفة الموجودات وأسبابها ومبادئها...».
وأما الفيلسوف؛ فهو الـمُشتَغِل بهذه الفلسفة، وقد برز من العرب والمسلمين عدد كبير من المشتغلين بالفلسفة، وهذا تعريف موجَز بعشرة منهم:
1. أوَّل هؤلاء الفلاسفة الذين ذاع صيتهم وانشغالهم بالفلسفة وعنايتهم بترجمة وشرح ودراسة الموروث الفلسفي اليوناني القديم، هو: الكِندي، وهو مِن أحد بيوت شيوخ قبيلة كِندة العربية، واسْمُه: يعقوب بن إسحاق بن الصبَّاح، أبو يوسف، الملقَّب بـ(فيلسوف العرب)، وُلِدَ في الكوفة سنة 185هـ -حيث كان والِدُہ واليًا عليها-، وقد تلقّىٰ علومہ الأوّليَّة في الكوفة، ثمَّ انتقلَ إلىٰ بغداد -عاصمة الخلافة العباسية- وحظِيَ هناك بعناية الخليفتَين (المأمون والمعتصم). وقد برع في العديد من العلوم، من أهمّها: الفلسفة والمنطق والرياضيات والطب والفلَك، وكان شاعرًا؛ وقد أكثرَ مِن الكتابة والتصنيف حتّىٰ ذكَروا لہ قُرابة ثمانين ومئتين كتابًا، ولم يصلنا منها إلا القليل. توفِّي في بغداد سنة 256هـ.
2. جاء بعْدَہ الفارابيُّ، واسْمه: محمد بن محمد بن طرخان، أبو نصر، الـمُلقَّب بـ(المعلِّم الثاني) علىٰ أنّ (المعلِّم الأوَّل: أرسطو). وُلِدَ أبو نصر في فاراب في إقليم تركستان عام 260هـ، ثمّ خرج من بلدہ بعد أنْ ناهز الخمسين من عمرہ قاصدًا العراق، وكان قد عكف في بلدہ علىٰ دراسة عدد من العلوم، كالرياضيات والفلسفة والآداب واللُّغات؛ وفي العراق أتمَّ دراسة ما بدَأہ في بلدہ، ثم انتقل إلىٰ مناطق عدّة، واستزاد من العلوم كالطبِّ والمنطق والموسيقىٰ...، وكان منقطعًا إلىٰ التعليم والتأليف، فقد بلغت مؤلَّفاتُہ عددًا كثيرًا، مما جعل أحد المستشرقين يخصِّص لها مجلَّدًا ضخمًا، لكن لم يصلْنا منها إلا القليل -كسابقہ-. وقد توفِّي في دمشق سنة 339هـ.
3. ويليه الراغب الأصفهاني، واسمه: الحسين بن محمد بن المفضَّل، أبو القاسم، اختُلفَ في تحديد القرن الذي عاش فيه، والراجح أنه من أهل القرن الرابع الهجري، وله مصنّفات ذائعة الصيت في الأدب واللغة والبلاغة والتفيسر، وفي الفلسفة والعقائد.
4. وفي ذات الحقبة ظهر ابن سينا، واسمه: الحسين بن عبد اللہ بن الحسن بن علي بن سينا، أبو عليٍّ، الملقَّب بالشيخ الرئيس؛ وُلِد في قرية من بالقرب من بخارىٰ عام 370هـ، وفي بخارىٰ بدأَ رحلة تلقّي العلوم، بدءًا من حفظہ القرآن ، ثمّ تلقّي علوم الفقہ والأدب والفلسفة والطب، وتنقَّلَ بين البلاد في سبيل العلم، حتىٰ مكث في همدان، وبها توفِّي سنة 428هـ؛ وقد خلّف موروثًا علميًا من المؤلّفات تزيد عن المئتين، وقد وصَلَنا منها عدد لا بأس بہ.
5. ومن معاصريه: ابن الهيثم، وهو أبو عليٍّ الحسن بن الحسن بن الهيثم، فيلسوف عالم، طبيب، مهندس؛ من أهل البصرة، ولد فيها عام 354هـ، ثم انتقل إلىٰ القاهرة وعاش فيها معتكفًا علىٰ العلم والتصنيف، حتىٰ توفي قرابة سنة 430هـ، وكانت لہ شروح ومقالات في الفلسفة والمنطق علىٰ الأصول التي وضعَها أرسطو. هذا وقد بلغت مصنّفاتُہ نحوًا من مئتَي كتاب، لم يبلغنا منها سوىٰ خمسين كتابًا.
6. ومن معاصريهم: المعَرِّي، وهو أبو العلاء، أحمد بن عبد اللہ بن سليمان، شاعر وفيلسوف وأديب مبرَّز، وُلِد في معرَّة النعمان في شمال بلاد الشام في سنة 363هـ، وبقي فيها مدىٰ حياتہ، لم يسافر عنها إلا مرَّتين -علىٰ ما ذُكِر-، وقد لُقِّب بـ(رهين المحبسين)، ولہ عدّة كتب ودواوين شعرية، وصلَنا منها قرابة خمسة عشرَ كتابًا ورسالة...، توفّي المعرّي في بلدتہ سنة 449هـ. وكان من المتأثّرين بالمتنبّي ومن رواة شِعرہ.
7. ومن معاصريهم لكن في الجهة الأخرى (الأندلس): ابن حزم، وهو أبو محمد، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، وُلِد بقُرطبةَ سَنَةَ 384هـ، إمام في الفنون، وَزَرَ بعْدَ أبيه للمُظفّر مِن حكّام الدولة العامرية، ثم ترك الوزارة وأقبل على التصنيف ونشر العلم. وَكَانَ قَدْ مَهَرَ ابتداءً فِي الْأَدَب، وَفِي المنْطِقِ والفَلْسَفَة. ثم أصبح فقيهًا مبرَّزًا، وعالمًا موسوعيًا يشار إليه بالبنان. وكانت وفاته سنة 456هـ. له مصنّفات كثيرة جدًّا، منها في المنطق والفلسفة، فضلًا عن الفنون الأخرى من طب وتاريخ ولغة وأدب وأصول وعقائد وفقه وحديث، وله ديوان شعر.
8. ثمّ جاء بعدَہ ابن رشد، واسمه: محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد، المعروف بالحفيد، كنيته: أبو الوليد، وُلد بقرطبة عام 520هـ في أُسرة معروفة بالعلم والفقہ، فصار فقيهًا مبرَّزًا، واشتغل بالفلسفة والمنطق وأكمل ما بدأہُ ابن حزم في نقدہ لمنطق أرسطو، وتصحيح مسار الفلسفة الإسلامية، كما كان طبيبًا وفلكيًّا وفيزيائيًا. حُورِب في آخر حياتہ وأُبعِد إلىٰ المغرب، وفيها توفّي سنة 595هـ. لہ من المؤلَّفات ما يزيد عن مئة كتاب.
9. ثم تلاہ حازم القرطاجني، وهو حازم بن محمد بن حازم القرطاجني، ولد في قرطاجنة شرق الأندلس سنة 608هـ، كان شاعرًا وأديبًا ناقدًا، وكانت له عناية خاصة بالفلسفة والمنطق. توفي في تونس عام 684هـ. له كتاب "ﻣﻧﮭﺎج البلغاء وﺳراج اﻷدﺑﺎء"، وديوان شعر.
10. وبالعَودة إلى جهة المشرق مرة أخرى نجد: ابن النفيس، وهو أبو الحسن علاء الدين علي بن أبي الحزم الخالدي، ولد بدمشق عام 607هـ تقريبًا، ونشأ وتعلم بها في مجالس علمائها ومدارسها، حتى صار عالمًا موسوعيًا يشار إليه بالبنان، وله إسهامات كثيرة في الطب، ويعتبر هو مكتشف الدورة الدموية الصغرى، وأحد رواد علم وظائف الأعضاء في الإنسان، حيث وضع نظريات يعتمد عليها العلماء حتى الآن. ومنكما له إسهامات أخرى في غير مجال الطب، كالفلسفة والمنطق، والفقه واللغة. توفي في القاهرة يوم الجمعة 21 ذي القعدة 687هـ، وخلّف موروثًا علميًا ضخمًا من حيث القيمة والمحتوى، وقد صل إلينا منه قرابة عشرين كتابًا.