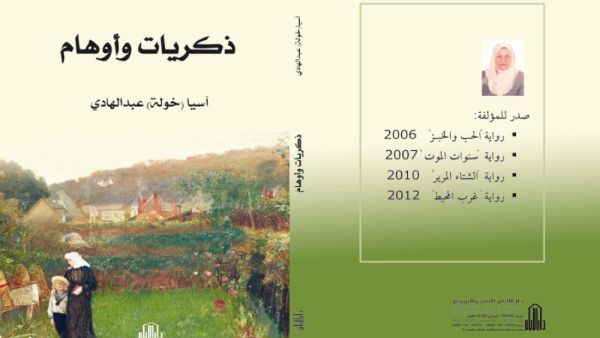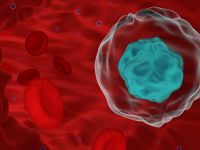ضمن محاولاتها التجريبية للنهوض بالرواية العربية، تُصدر آسيا (خولة) عبد الهادي روايتها «ذكريات وأوهام» التي تمتلك مفاتيح الغنى للفقراء، ومفاتيح السعادة للأشقياء، وتستحدث نوعًا جديدًا من السرد الذي يمكن أن نطلق عليه اسم «السرد السعيد»، القريب جدًا من سرد «ألف ليلة وليلة»، الذي يُقدّم الإمتاع والمؤانسة والتنفيس، والذي ينتصر فيه المظلوم على الظالم، والحق على الباطل، والنور على الظلام، والخير على الشر.
تستعرض الرواية، سيرة بطلها «أحمد»، الذي بدأ حياته جامعًا بين الدراسة ومشاركة والده (الفقير جدًا، والذي اضطر إلى مغادرة مصر مغتربًا) العمل في الحدائق المنزلية في الأردن، وسرعان ما تتعاطف معه إحدى سيدات المجتمع (أم كريم) فيعمل في حديقة منزلها، وتنعم عليه، وتدعمه وأسرته ماديًا ومعنويًا، وتحميه من استفزاز زوجها ولؤمه.
وحين تطمئن له أكثر، تفتح له قلبها، وتسرد له جانبًا من قصة حياتها، وما جرى لوالدها المجاهد، الذي طارده الانتداب البريطاني في ثلاثينات القرن الماضي، الأمر الذي اضطره للسفر إلى فنزويلا، ليتعرف هناك على مسيحي كان له دور كبير في المقاومة في فلسطين في النصف الأول من القرن العشرين.
وتمضي الرواية في أحداثها التي تجبر «أحمد» على مغادرة الأردن، والعودة إلى مصر مع والده، دون إعلام «أم كريم»، وبعد أربع سنوات يعود ليبحث عنها، فيجدها أيضًا قد سافرت في اليوم الذي سافر فيه، تاركة له رسالة لدى محام يبلغه أنها قد وهبته بيتها، ثم يستقر في البيت الذي يجاور منزلًا تسكن فيه مجموعة من بنات الهوى، ويحدث أن تتعرض إحداهن للقتل أمامه، فتبدأ معاناته بسبب شعوره أن البيت مسكون بروح «أبو كريم»، وروح المرأة التي سُفك دمها أمامه، ولا يتخلص من هذه الكوابيس إلا ببيع البيت للبلدية ليصبح مكتبة عامة، ويعود هو إلى مصر، ويواصل دراسته حتى ينجح، ويتزوج من زميلته في الجامعة.
تـُخرج هذه الرواية قراءها من وضعهم الطبيعي، وتجعلهم في حالة الغليان، فالروائية تخاطب القاعدة الشعبية، بكل ما فيها من فقر وعوز وحاجة، وبكل ما لديها من طموح للتغيير، منطلقةً من أقصى ما تملك من العواطف الصادقة، والمشاعر الطيبة، باذلة أقصى جهودها لنقل حالة التأثر التي تعيشها لتؤثر فيهم، وهذا هو دأبها في رواياتها السابقة، فبقدر ما يمتلك المرء من رجولة، سرعان ما ينهار ويندفع بالبكاء من شدة التأثر.
تمزج الروائية بين الخاص والعام، وبين الثقافي والسياسي، وتجعل من القضية الفلسطينية، والصراع العربي الصهيوني، وتمجيد المقاومة والمقاومين، هدفًا رئيسًا تخفيه، ولكنه سرعان ما ينكشف حين تتحدث عن الوحدة الوطنية، وعن دور المسيحيين الفلسطينيين في التصدي المبكر للوجود الصهيوني في فلسطين في النصف الأول من القرن العشرين، وكذلك حين تتحدث عن عذابات اللجوء وتـُحرّض على التمسك بحق العودة، عدا إشارتها لتأثير معاهدة السلام على الأوضاع المعيشية للسكان.
نجحت الروائية في التخلص من الجانب التسجيلي في الرواية، وحافظت على فنيتها العالية، رغم اتكائها على أحد كتب المذكرات، وتوثيقها المصدر، هذا عدا ما بثته من لوحات تشكيلية في أثناء وصفها الجميل لفلسطين وأهلها في الربع الأول من القرن الماضي، حيث هداوة البال والزمن الجميل. وهي تتجاوز الوصف أحيانًا وتدخل في باب الأدب الساخر، وبخاصة حين تصف الذين أطلقوا على الدراجة الهوائية (البسكليت) حين رأوها لأول مرة اسم «الحمار الحديدي»، وحين يفقد بطل الرواية مفتاح المنزل، ليجده بعد أيام من البحث والتنقيب مشبوكًا بكيس طعام في (فريزر) الثلاجة.
وتقوم هذه الرواية على المونولوجات الداخلية، وتيار الوعي، باعتبارها من أدوات الاسترجاع، والاستذكار، وإسقاط الماضي على الحاضر، في الوقت الذي كانت الروائية تستشرف فيه المستقبل الأجمل والأفضل للمعذبين في الأرض، والكادحين في القاعدة الشعبية، ممن يُسلّط عليهم القدرُ لؤماء لا يرحمون، لتدعو بشكل مباشر إلى احترام إنسانية البشر ومشاعرهم.
وضمن مزجها بين الخاص والعام، تشتمل الرواية على أنواع عدة من السير: الفردية، والجـَمعية، والغيرية، والشعبية، في أكثر من قُطْر، لا سيما وأن شخصيات الرواية كانت تعيش في مصر والأردن وفلسطين وفنزويلا، وتستعرض الروائية فيها حياة بطلها في طفولته وفي شبابه وفي كهولته، وفي علاقته مع المجتمع المحيط به، وتواكب نموّه وتطوّره حتى تجعله يمتلك المال والعلم والزوجة الصالحة والأسرة السعيدة، بعد أن مرّ بمنعطفات حادة، كادت تسلبه روحه وعقله.
وحين كانت الروائية تغادر هذه الحالة الفردية، نجدها تـُبرز هنا وهناك دبابيس تمسّ المسؤولين عن تدهور الوضع الاقتصادي وممارسي الفساد، ومهربي الركّاب في البواخر التجارية، وتمسّ أيضا الوضع الاجتماعي والمسؤولين عن المتاجرة بـ»بنات الهوى»، عدا العلاقة السيئة بين الحماة والكــنّة وأثرها على أفراد الأسرة كافة.
والروائية مغرمة بالغرائبية، والعجائبية، والفنتازيا، واللامعقول، ولديها القدرة على جعل القارئ يعيش حياة بطلها المليئة بالأشباح والأرواح، وسرعان ما يستسلم لقدره بعد أن تـُصبح لديه القدرة على سماع صوت الموتى والأشباح والأرواح، ومراقبة حركاتهم، والعيش في بيئة مليئة بالرعب، والغريب في ذلك كله، أنه يتم بعد أن يمتلك مَن تصيبه هذه الحالة، ما كان يتمناه من غنى وسعادة، وكأننا به بين ثنائيتين: الفقر والتعاسة، أو الغنى والجنون.
آسيا عبد الهادي، التي تكتب القصة والرواية الواقعية، لا تستطيع لجم خيالها المـُحلّق، ولا حرمان حواسها من لذة الاستشعار والاستكشاف، ولا تستطيع أيضا إيقاف عقلها وما فيه من قدرة على الاستبطان والتحليل والتقييم والتفلسف، فكيف يكون الأمر حين تضيف لذلك كله، ذاكرة حديدية لا تنسى، وقدرة على سرد التفاصيل الصغيرة والكبيرة، التي تجعل من الحياة، فيلمًا سينمائيًا مكثفًا ومُشوّقًا، يقرأه المرء ويشاهده في آن.
تمتلك الروائية جماليات متقدمة، جعلتها تُبدع رواية تدور أحداثها، وأمكنتها، وأزمنتها، وشخصياتها، على رمال متحركة، فهي ضد الثبات، وخيوطها بحاجة إلى ضبط على أكثر من صعيد، ورغم ما فيها من تداخل وامتزاج، وتناقض وتضاد، إلا أنها نسجتها بدقة وإتقان وجمال، وأنهتها بالزواج، وما فيه من إنهاء لسنوات من القهر والعذاب والكد والمغالبة.
كتبت آسيا عبد الهادي روايتها بالعربية الفصحى، محافظة على الأسلوب السهل الممتنع، ومتخلية عما كانت تبثه في رواياتها السابقة من مصطلحات خاصة بالنساء، ولكنها كانت تـُمرر أحيانًا بعض الكلمات الأجنبية في السياق دون أن تجعل القارئ ينتبه، ومن ذلك كلمة (أباجور)، في وصف أحمد لمنزل سيّدته بعد سفرها بأربع سنين.
أما الاغتراب في الرواية، فبقدر ما فيه من عذاب وقهر وألم روحي وجسدي، والذي كان سيفًا ذا حدين، يمس أحدهما المغترب نفسه، ويمس الآخر أهله الذين يتمنون عودته، إلا أنه كان يقدح زناد الفكر للبحث عن حلول للمشاكل التي أدت للسفر، وفي مقدمتها المال، الذي قالت الرواية عنه إنه هو الذي يتكلّـم ومن لا يملكه يخرس، وتصف الروائية معاناة المغتربين عبر قولها: «الآباء يكافحون ويعانون ويتعبون ويعملون بجهد ويضحّون بأجمل أيام أعمارهم ويعايشون الوحدة والغربة والبرد والجوع والشوق، ينامون كيفما كان ويأكلون الخبز الحاف ويرتدون الخرق البالية بعيدين عن أسرهم وزوجاتهم.. إذا مرضوا لا يجدوا من يعتني بهم، وإذا تعثروا لا يجدوا من يواسيهم، يكتمون آلامهم وشقاءهم ويوهمون الآخرين بسعادتهم».
والاغتراب نفسه، جعل من هذه الرواية، رواية مركبة، تقوم على جملة من القصص والحكايات، وقد وصفت الروائية نفسها ذلك حين عرضت ما جرى لإحدى شخصيات الرواية: «القصة تلو القصة، والحكاية تلو الحكاية، تحدّث عن الناس والبلاد، لباسهم وطعامهم وعاداتهم ونساءهم، مناخهم ومدنهم، حكايات لا تنتهي وأسئلة متتالية».